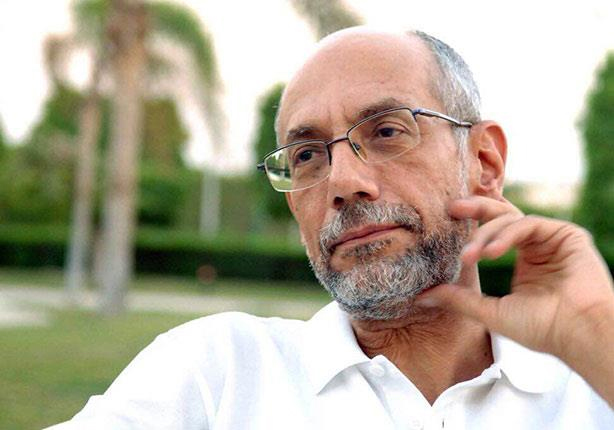
«اللجنة».. حقائق، وإشكاليات، وأسئلة

أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا.
كان هذا هو ردي الأول على من نقل لي ما فُهم أنه خطوة «جادة هذه المرة» نحو الإفراج عن آلاف المظلومين القابعين (بعضهم لسنوات ثلاث) في سجون مصر التي أصبح «الظلم» علامة مسجلة على أيامها تلك.
أسعدني الخبر، بعد أن تخيلت حال كل من صعد به الأمل إلى السماء مع كل وعد رئاسي سابق، لم يتحقق. وها هو يسمع أن تلك المرة مختلفة.

في الملف «الموجع» الذي أربكه غياب ما عرفه النظام القضائي المصري العريق من قواعد عدل حاكمة، فضلا عن آلة شيطنة «مكارثية» إعلامية جبارة كفيلة بتأثيم حتى الملائكة، ووسط هيستريا «التشفي» من ناحية، وصناعة الخوف من ناحية أخرى. وبحثا عن «شرعية» لا تستند واقعيا إلا إلى نفي الآخر، وجد المظلومون والأبرياء طريقهم إلى السجون التي لم تشهد في تاريخها ربما ما تشهده هذه الأيام من ازدحام.
في الملف المزدحم قوائم لا نعرف عددها «لسجناء رأي»، إذا اعتمدنا التعريفات المعتمدة في المراجع القانونية والمعاهدات الدولية، لم يحملوا سلاحا يوما. بل وبعضهم لم يكن يعيش في مصر أصلا (الباحث إسماعيل الإسكندراني الذي اعتقل في المطار حين قدومه لزيارة والدته المريضة)
وفي الملف المزدحم أيضا قوائم «لسجناء صدفة» تصادف أن كانوا في الشارع «في المكان الغلط.. وفي اللحظة الغلط». في تكرار تراجيدي لكوميديا «إحنا بتوع الأتوبيس» التي جسد لنا فيها الراحل حسين كمال كيف تجسد لنا الدولة البوليسية المثل العربي القديم «شر البلية ما يُضحك». وهو فعلا شر البلية، حين يعتاد القائمون على إنفاذ القانون ثقافة تغيب فيها فلسفة القانون، الذي ما وُجد، وما اخترعه الإنسان إلا ليستقر العدل.. والذي بدونه تنهار المجتمعات، مهما كانت القشرة الخارجية براقة ولامعة. هل تذكرون إلى أين انتهت بنا رحلة «أتوبيس حسين كمال»؟ الإجابة المختصرة والدالة: إلى هاوية يونيو ١٩٦٧.
***
ثم إن في الملف «المزدحم» الذي أتصور أنه سيكون أمام «اللجنة» التي يرأسها الدكتور أسامة الغزالي حرب عدد من «الحقائق»، لا أتصور أن لجنة أنيط بها مهمة بهذه الخطورة يمكن أن تغفل عنها.
أولها أن «اللجنة» واقعيا، لا تعمل في فراغ. فهناك، إلى جانب الواقع السياسي المرتبك والمضطرب «والصاخب» بالصارخين؛ المتربصين المتعيشين على هذه الحالة من الاستقطاب «والقلق المجتمعي»، هناك واقع تشريعي يعرفه المتخصصون، وربما كان علينا بداية أن نبسطه للقارئ غير المتخصص. وأعود هنا في عُجالة إلى ما سبق وفصلته في سلسلة مقالات عن الموضوع («الشروق»: ١٨ و٢٥ سبتمبر / ٢ أكتوبر ٢٠١٦)
من الناحية القانونية، فقرارات العفو أنواع:
أولها: «العفو عن العقوبة»، كما يقول المصطلح القانوني. وهو على صورتين:
١ـ إحداهما: تلك «الروتينية» التي تصدر في المناسبات والأعياد « للعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية» لبعض المحكوم عليهم الذين نفذوا نصف مدة العقوبة، أو عشرين عاما للسجن المؤبد، (أو غير ذلك من التفاصيل). ومثال ذلك القرارات الجمهورية الروتينية التي يصدرها رئيس الجمهورية في المناسبات الدينية والقومية. والقرار في هذه الحالة لا يصدر محدِدا للأشخاص أو للجرائم، بل يصدر مقرِرا المعايير التي في حدودها تضع الجهات الأمنية قوائم المفرج عنهم. ويسري ذلك القرار عادة، على المحكوم عليهم من الجنائيين. ومن نوعيته تلك القرارات الأخيرة التي احتفى بها الإعلام محاولا الإيهام (على خلاف الحقيقة) أنها قرارات العفو التي ينتظرها الناس.
٢ـ أما الصورة الثانية لقرارات «العفو عن العقوبة» التي يملك رئيس الجمهورية الحق في إصدارها بموجب المادة ١٥٥ من الدستور، فهي تلك ذات الطابع السياسي، وتصدر عادة لرفع الظلم الواقع «على المظلومين الموجودين في السجون» كما وصفهم الرئيس السيسي مرتين، أو لتخفيف التوتر والاحتقان وعمل انفراجة مطلوبة في المناخ العام. وهذا هو «العفو» الذي يقصده «اصطلاحا» الحوار المجتمعي العام. وهو الأمر الذي لم يحدث في العامين الماضيين إلا مرتين: إحداهما بقرار صدر في يونيو ٢٠١٥ وشمل ١٦٥ اسما، والثاني في سبتمبر من العام ذاته وضمت قائمته مائة من المحكوم عليهم، من بينهم صحفيو «الجزيرة» الذين كانت الحملات الدولية للإفراج عنهم تمثل في حينه صداعا للدبلوماسية المصرية.
وقرارات «العفو عن العقوبة» تلك، بصورتيها لا يملك رئيس الجمهورية إصدارها طبقا للدستور إلا على الذين صدرت بشأنهم بالفعل أحكام نهائية. حتى يكون هناك «عقوبة» يمكن العفو عنها أو تخفيفها. أما «المحبوسون احتياطيا على ذمة قضايا»؛ سواء بقرار من النائب العام، أو القاضي الذي ينظر قضاياهم، ولم يصدر بشأنهم حكم بعد، بإدانة أو براءة. فلا تمتد إلى أوضاعهم سلطة رئيس الجمهورية «بالعفو عن العقوبة». لأنه ببساطة لا توجد «عقوبة» بعد.
النوع الثاني من قرارات العفو، تُعَرّفه المصطلحات القانونية «بالعفو الشامل»، ويعني العفو «عن الجريمة»، بمعنى محو الصفة الإجرامية عن فعل ما ليصبح في حكم الأفعال المباحة، أو محوها عن شخص ما أو مجموعة من الأشخاص، فتسقط بالتالي كل الآثار المترتبة على حكم الإدانة المقصود. ويحدث عادة في مراحل التحول السياسي، بهدف فتح صفحة جديدة. (من أمثلة ذلك المرسوم بقانون رقم ٢٤١ لسنة ١٩٥٢) ويعرف القانونيون أن هذا «العفو الشامل» بهذه الصيغة لا يكون إلا بقانون، كما ينص الدستور.
***
اتصالا بهذا الإطار التشريعي الذي من المفترض أنه حاكم لأعمال «اللجنة»، تبقى أخطر الحقائق على طاولتها أن «الإعلان الرسمي» عن اللجنة ومهامها جاء في نصه أنها: «… لإجراء فحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بشأنهم أحكام قضائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوما على الأكثر، لاتخاذ ما يناسب من إجراءات وفقا لكل حالة على حدة، طبقا للقانون والدستور والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية»
حسب «النص» الواضح، فمناط عمل اللجنة هو «الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا، ولم تصدر بشأنهم أحكام قضائية». والمعلوم لكل مشتغل بالقانون، وكل مطلع على الدستور. أن أولئك تحديدا لا تمتد إليهم سلطة الرئيس، بل يخضعون للسلطة القضائية؛ نائبا عاما لمن مازالوا رهن التحقيق. أو قضاة (على اختلاف دوائرهم) لمن أحيلوا للمحاكمة، وما زالوا محبوسين. وعلى هذا يصبح مناط عمل اللجنة، الذي يشير إلى «التنسيق» مع الجهات المعنية (كما ورد في الإعلان الرسمي عنها) محاطا بعلامات استفهام مقلقة، بل وربما «مؤسفة» في دلالتها.
والحاصل أننا (في ضوء ما يقضي به الدستور والقانون) أمامنا، نظريا ثلاثة سيناريوهات:
الأول: أن ينتهي عمل اللجنة «واقعيا» إلى لا شيء. لأنها في حال التزامها بما أوكل إليها من فحص لحالات «المحبوسين احتياطيا» ستخرج بقوائم لمن لا يملك الرئيس الإفراج عنهم في ضوء سلطته في «العفو عن العقوبة» والتي تنحصر في الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية، كما تقضي المادة ١٥٥ من الدستور.
السيناريو الثاني (والذي لا أريد حتى أن أتصور وجوده): هو أن الذين فكروا في الأمر (أو الذين صاغوا نص الإعلان عنه)، لا يجدون ثمة حرج في إنهاء الموضوع، إفراجا عن البعض «بالتنسيق مع الجهات المعنية» والتي هي هنا، بحكم الدستور (السلطة القضائية)، التي من المفترض أنها «مستقلة»، ويمثل التدخل في شئونها «جريمة لا تسقط بالتقادم» (المادة: ١٨٤ من الدستور)
السيناريو الثالث، ولعله الوحيد الذي يتسق مع القانون: أن يكون هناك من يفكر في «العفو الشامل» كإجراء قانوني وحيد يستند إلى مرجعية دستورية، بعد أن أدرك (أخيرا) حاجة هذا الوطن إلى استعادة لُحمته الوطنية، وأن يشعر مواطنوه كافة بالعدل والمساواة، (فيتحقق الرضا المجتمعي، ومن ثم الاستقرار). وهو الأمر الذي تقول تجارب السابقين أنه لن يتحقق إلا إذا التزمت السلطة الحاكمة بالعناصر الخمسة التي تعرفها العلوم السياسية الحديثة «بمقتضيات العدالة الانتقالية» Transitional Justice التي تمثل الطريق «الوحيد» لاستقرار المجتمعات بعد الهزات الكبرى. وهو الأمر الذي بُح صوتنا في المطالبة به على مدى السنوات الست الماضية، دون صدى يذكر عن أي من الذين أوكل إليهم أمر إدارة البلاد بعد الحادي عشر من فبراير ٢٠١١. لا أستثني أحدا. (أكرر: لا أستثني أحدا).
***
أيا ما كان «السيناريو»، ودلالاته، وتداعياته، فسيظل أمام اللجنة في هذه المرحلة المبكرة من عملها أسئلة لا يمكن إغفالها، إذا كان القصد أن تحقق ما نصبو إليه جميعا من تحقيق «عدالة غائبة». من قبيل تلك الأسئلة:
١ـ في غيبة قرار جمهوري يحدد الإطار القانوني لعمل اللجنة وصلاحياتها، ماهي حدود علاقتها بأجهزة الدولة ذات الصلة؟ وهل بإمكانها أن تطلب البيانات التي لا غنى عنها لتأدية عملها؟ 
٢ـ هل هناك لدى اللجنة قوائم (مفصلة) بأولئك المحبوسين، لتتمكن اللجنة من فحص حالاتهم؟ ومن أين لها بالوسيلة العملية «العادلة» لفحص تلك الحالات؟ أم أن الأمر سيقتصر على استقبال مناشدات من الأسر، يجري بناء عليها إعداد قوائم ترسل إلى الأجهزة الأمنية، لتصدر هي «القرار النهائي» بناء على التحريات «المرسلة»، التي بموجبها أصلا دخل هؤلاء السجن؟
٣ـ ماذا نقصد «بالشباب المحبوسين» الذين ورد ذكرهم في الإعلان عن اللجنة؟ وما حال «الشيوخ» مثلا، وبعضهم تجاوز عمره الثمانين عاما، بكل ما يعنيه هذا من وضع صحي مفهوم؟ وما هو العدل في التمييز بين هذا وذاك؟ بل وما هو الوضع القانوني لمثل تلك القرارات الانتقائية؟
لا أعرف إجابة الأسئلة. ولكنني أعرف أننا لسنا بصدد اختراع العجلة (وإن كنا نبدو دائما كذلك)، فلعلي أبادر بأن أضع أمام «اللجنة الرئاسية» سوابق ذات صلة، لعمل لجان «حقيقية» صدرت بتشكيلها في حينه «قرارات جمهورية» نُشرت في الجريدة الرسمية. وهي كأي قرارات «منضبطة» تحدد الإطار القانوني لعمل اللجنة، واختصاصاتها، على سبيل الحصر. ولأن الهدف كان وقتها حقيقيا وواضحا في إزالة مظالم ترتبت على الخلط بين الأوضاع القانونية في الأحوال المستقرة، وتلك المختلفة وقت الثورات والتحولات. والتي بطبيعتها تبيح ما قد يكون مجرما في الأحوال العادية.
لن تسمح مساحة هذا المقال بعرض أعمال تلك اللجان، ولكن لعل المثال الأوضح لها هو ما تم في «لجنة الحرية الشخصية»، التي تشكلت بموجب القرار الجمهوري رقم ٥ لسنة ٢٠١٢ برئاسة المستشار أمين المهدي، والتي أنيط بها مراجعة أحوال المعتقلين، والمحكومين من دوائر القضاء العادي، وكذلك المدنيين الصادر ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية في الفترة من ٢٥ يناير ٢٠١١، وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٢. ويومها انتهت أعمال اللجنة إلى التوصية بإصدار قرار بقانون بالعفو الشامل عن الجرائم ذات الصلة أيا ما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم؛ سواء صدر من إحدى محاكم القضاء العادي أو محاكم أمن الدولة طوارئ أو المحاكم العسكرية. مع النص الصريح على «وقف السير في القضايا التي مازالت منظورة أمام المحاكم، والمتعلقة الاتهامات فيها بذات الجرائم.. وقد كان.
***
يبقى أنه فيما سمعته من الدكتور حرب، عندما ناقشته في الأمر من إصرار على أن تحقق هذه «اللجنة» شيئا له قيمة، ما يدعو إلى التفاؤل، ولأن مما لا يكتمل الواجب إلا به فهو واجب، فربما كان من «واجب التفاؤل» هنا أن نُذَكّر (معه) بضرورة ألا يكون مصير جهد هذه اللجنة (خاصة مع ما سُلط عليها من أضواء) هو ذاته مصير جهود سابقة «ووعود» سابقة.
إذ في الملف «الموجع إنسانيا» أن هذه، لم تكن «المرة الأولى»، أو الوعد الأول، الذي ظل «إعلاميا ــ وفقط» دون أن يجد طريقه إلى الجريدة الرسمية بقرار يرفع «بعض» الظلم، ولو عن «بعض» المظلومين. ففي يناير من هذا العام (الذي تم إعلانه «عاما للشباب»)، ذكرت الصحف أن الرئيس سيصدر خلال أيام قرارا جمهوريا بالإفراج عن أكثر من مائة من الشباب المسجونين («الوطن»: ٩ يناير ٢٠١٦)، إلا أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية فاجأ المنتظرين (أمهات وآباء وزوجات وأبناء) مساء الخامس والعشرين من يناير ذاته بتأكيده على أنه «لم ترد إلى الوزارة أية قرارات بصدور عفو رئاسي (!) … مشيرا إلى أن ما صدر فقط هو قرار بالعفو عن المساجين الذين أمضوا نصف المدة في قضايا جنائية». وهو الأمر الذي تكرر مثله في مارس عندما التقى الرئيس بالمثقفين، ثم في أغسطس من العام ذاته وبصيغة أكثر تحديدا حين قال الرئيس في حواره المنشور مع رؤساء تحرير الصحف القومية: «سوف يصدر خلال أيام قرارا بالعفو والإفراج عن ٣٠٠ شاب من أبنائنا، منهم أصحاب حالات صحية وإنسانية وأشقاء وشباب شاركوا في تظاهرات. ومنهم تخصصات مختلفة، ومنهم صحفيون..»
***
وبعد..
فكنا قد قرأنا قبل أكثر من ثلاثين عاما رواية صنع الله ابراهيم «اللجنة»، والتي كان كتبها في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، ليرصد بوقائعها الفلسفية الرمزية، لحظة انكشاف حقيقة المسافة الشاسعة بين شعارات «الدولة» العربية الحديثة، وبين حقيقة أنظمتها ودينامياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي لا تمت بصلة إلى هذا الشعارات. وكلي أمل أن تثبت لنا «اللجنة» التي تتعلق بها أنظار وآمال آلاف الأمهات والأبناء اليوم أن ما يقال على المنصات أمام الميكرفونات والعدسات، يمكن أن يجد طريقه «الحقيقي» لا الشكلي إلى أرض الواقع. وأذكر بأن هذا لن يتحقق أبدا بقائمة تأخذ هذا وتترك ذاك (حال تساوي مراكزهما القانونية). كما لن يتحقق قطعا بقائمة شكلية تضم العشرات، وتترك المئات، بل وربما آلاف المظلومين خلف أسوار السجون.فالعدل هو العدل. وقاعدته التي تعلمناها من ديننا أولا، ومن شيوخ قضاتنا ثانيا تقضي بأن براءة مائة مذنب خير من عقاب بريء واحد.
نقلا عن الشروق
